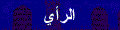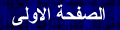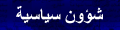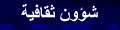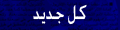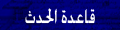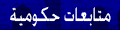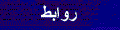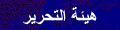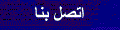|
موت المؤلف ملحق ثقافي وبقي المؤلف وحياته العنصر الأول والمهم في العملية الإبداعية، وأحد العناصر الكثيرة التي غلفتها الميتافيزيقيا كذات متسلطة وحضور متعالٍ، وظل المتلقي مهمشاً وإن كنا نجد لنظرية التلقي جذوراً في التراث النقدي عند بعض الكتاب أمثال ابن قتيبة وحازم القرطاجني وغيرهما، والغالب على كتب التراث النقدي الكثير من الإسقاطات الخارجية والتاريخية في الدراسات الأدبية باعتبار أن الحضور الخارجي ساهم في عملية الخلق الإبداعي من ثقافة واجتماع ومعتقدات وظروف أنتجت النص وغير ذلك من إسقاطات خارجية. وفي العصر الحديث مع انتعاش البنيوية ومابعدها، بدت جدلية موت المؤلف ركيزة مهمة في الدراسات اللسانية التي اعتبرت أن المؤلف أداة فقط في إنتاج النص كما فعل "جاك لاكان" الذي غلّب سلطة اللغة على سلطة المؤلف في دراسته "لإدجار آلان بو". لقد شرّعت وصرّحت البنيوية بموت المؤلف في الدراسة الأدبية لأن النص شبكة تؤلف نظاماً قائماً بذاته دون الحاجة إلى الرجوع لما هو خارج عنه، وإحلال مفاهيم جديدة محلّ الإنسان «نسق – بنية – تشيؤ – منظومة – دال – مدلول – تزامن – تعاقب «وبموت المؤلف تتعدد القراءات بدلاً من قراءة أحادية المعنى، وسيلج إلى النص أعداد من القرّاء غير محددة الهوية، تتنقل بين عتبات النص متسائلة.
وبانتهاء سلطة المؤلف ساهمت الدراسات اللسانية بإعادة اللغة لمكانتها بعد انحسارها طويلاً، وباسترجاعها لمكانتها سيبدو النص حصيلةً للفكر، وتتجسد ثنائية لسانية من حيث الموضوع: جانب ذاتي متصل بالكلام، وآخر موضوعي اللغة فيه منجزة من خلال علاقتها الداخلية، وبالتالي فإن المعنى اللغوي ليس من إنتاج ذات بقدر ماهو نتاج النظام الدلالي اللغوي. لقد اكتفت البنيوية باللغة وروجت لفلسفة قتل المؤلف كما فعل بارت مدّعياً أن الفاعل تحدده اللغة بعيداً عن الشخص، وبحضور الكتابة ينتفي الصوت الممثل بالمؤلف، وبذلك قال " بول فاليري " الذي أولى اهتماماً بالغاً باللغة. لقد انطلقت البنيوية في فلسفتها بقتل المؤلف من فكرة أن الكتابة عمل لاشعوري ونتاج للحلم، وعند إقصاء أو قتل المؤلف سيولد النص من جديد حسب " أمبرتو إيكو ". لكن البنيوية غالت كثيراً في التمركز النصي متموقعة ضمن نسق مغلق، وهذا ما آذن بانحسارها وولادة التأويلية ممثلة بـ " جاك دريدا " عبر إعادة الحيوية للقراءة وانفتاحها على النص، إلا أن الدعوة لانفتاح القراءة وتفكيك النسق المغلق لم يلغِ الدعوة إلى موت المؤلف. لقد أزاحت البنيوية الشكلية الذات الإنسانية واستبدلتها بمقولة البنية من خلال نسق منتظم ببنية لغوية لها أنساقها ونظامها المغلق عن التصورات البرانية متمردة في ذلك على ثنائية الشكل والمضمون المزمنة في مسيرة النقد الأدبي، أما الاتجاهات البنيوية الأخرى كالبنيوية التكوينية فقد نهجت مساراً عكسياً من حيث حضور الذات المبدعة، فهي لا تنفيه تماماً في ممارستها النقدية لأن حياة المؤلف تنطوي على دور بارز في دراسة العمل الإبداعي وفهمه، وكذا فعلت التأويلية بانفتاح قراءاتها من حيث العلاقة الإشكالية بين العمل الأدبي وقراءته. أمّا في الدراسات العربية فقد تباينت الآراء وتضاربت، فمنهم من أراد العيش على المنجز الثقافي العربي القديم، وتكراره بشكل جديد من خلال حضور المؤلف كسلطة رئيسية في دراسة النص، ولي عنق النص بفرض إسقاطات عبر أسئلة جاهزة محملة بأجوبتها «دراسة سياقية «بالالتفات إلى سيرة المؤلف وحياته الذاتية التي تُعتبر مفتاح الدراسة، وهذا المشهد النقدي مازال يُمارس حتى الآن، مثلاً : قبل أن ندرس نصاً للمتنبي سنأتي بحقيبة مليئة بأسئلة وأجوبة عن شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس، باحث عن المجد، عاصر أحداثاً جساماً، فارس خاض الحروب... إلخ، وكذلك لو أردنا دراسة نص لأبي العلاء ترانا سنبدأ من حياة شخص ضرير» أعمى «تكوينه العقلي قلق حيال العالم بأسره، يكره النساء... إلخ، كما فعل – مثلاً – العقاد في دراسة شعر ابن الرومي من خلال نفسيته، وهكذا دواليك حيال نصوص أخرى باستحضار حياة المؤلف وسيرته وعصره ثم نمارس ونسقط كل هذا على النص لإثباتها» قراءة سياقية قسرية». وعلى الطرف النقيض من الطرف الأول في الدراسات النقدية العربية جاء من يدعو لنسف القراءة السياقية واستبدالها بقراءة نصوصية متسحلين بفكر مستورد بشكل مشوش، فكثرت الدعوة إلى موت المؤلف وضرورة الانفتاح على المنجز النقدي الغربي، والدفاع عن هذه الدعوة بشكل قوي إلى درجة الخضوع التام الذي لم يخلُ من تشويش وضبابية في الرؤية والرؤيا من حيث النظرية والتطبيق، ووصل هذا إلى حدّ الإجابة المطلقة لكل الأسئلة من خلال التقيد بالنموذج الغربي كلازمة أو مسلّمة لا تقبل النقد ولا المناقشة، وهذا بدوره أعاد الدور السلطوي الذي مورس على النقد لسنوات، وتمت إعادة قولبة المركز، فبينما دعت الدراسة السياقية لمركز متعالٍ في الدراسة النقدية جاءت الدراسة النصية لتمركز العملية النقدية بطرف متسلط «النص «. إن الدعوة العمياء لفرض الدراسة النصية فقط لم تعِ أن المشكلة المعرفية التي انبنى عليها العقل الغربي مستندة إلى مرجعيات وفلسفات مرتبطة بمفهوم الإنسان في الفكر الغربي، وتلك العملية ليست بالضرورة أجوبة نهائية أو شبه نهائية لمشكلة المعرفة في العقل العربي نظراً لمرجعياته وثقافته وفلسفته، وهذا ماجعل الصورة الجديدة ناسخة للدرس الفكري والنقدي الغربي، وهذه الدعوة للأخذ بالمنجز الغربي لم تشرّح النظرية الغربية بأبعادها ومرجعياتها وظلالها التي انبثقت عنها، فجاءت «الدعوة «غير حوارية من حيث جدلية موت المؤلف، وتمت الدراسة النقدية العربية عند هذه الجماعة على غرار البنيوية «قراءة نصوصية بحتة» دون الالتفات إلى مبدعها إمعاناً منهم بأن النص هو صاحب السلطة الحقيقة ولا جدوى من الالتفات لما هو براني، وهذا جعل من دراساتهم أداة وطريقة إجرائية تعيد المقولة البنيوية على الرغم من انحسارها في الغرب.لقد وقع النقد العربي في أزمة حول تبرير الدوافع والمسوغات إن كان للقراءة السياقية أو النصية، وإن عدم انتظامها يعود إلى أنها منتزعة من سياقها المعرفي بشكل إجرائي. وأمام هذه الثنائية في الرأي النقدي العربي لم تغب الرؤية النقدية الفاعلة، فهناك من تبرّم من القراءة السياقية وإسقاطاتها ومع ذلك لم يقل بموت المؤلف ودوره، وأكد بعض النقاد العرب على عدم الانزلاق وراء أطروحات البنيوية الغربية التي لم نجد لها مسوغات فلسفية في ثقافتنا العربية. إن النص الأدبي شبكة من علاقات داخلية وخارجية تستحوذ علينا، فنحن في المقام الأول نتذوق النص جمالياً ونتحرر من الأحكام المسبقة الصنع، ونتوغل في جماليته متجاوزين الرؤية السطحية إلى استجابة داخلية، ثم بناء واعٍ في التفكر والتحليل من خلال اندماج القاريء بالمقروء، والإبحار في النسيج اللغوي والميتا لغوي في قراءة عبر نصوصية، من خلال جدلية الخفاء والتجلي، والمقول والمسكوت عنه، قراءة نصانية تشريحية.
|
||||||||||||||||