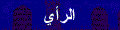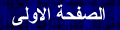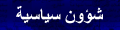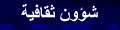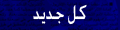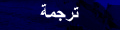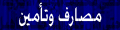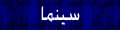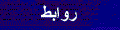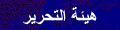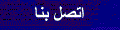|
أحمد دحبور.. سلامتك آراء ذكريات من غرف جريدة الثورة أيام كان مقرّها خلف القصر العدلي, حيث يأتي إلى هناك ونتجمع في غرفة فيلعلع صوت ممدوح عدوان وغيره ممن كانوا في عدادنا كمحررين أو أصدقاء لنا. كنتُ أجد في هدوء أحمد دحبور: مسحة من الأسى رافقته- كما أظن- بقية حياته.. مسحة تشي بالألم الداخلي. وتطلعاًلغد لابد أن يأتي. فَتَحْتَ جلده وفي القلب ثمّة حزن يعتصره: فهو ابن النكبة وابن المأساة التي لايزال التاريخ يروي حكاياها وأحزانها ومعاناتها: حتى الآن.. كانت فلسطين وأهلها في قلبه وشعره.. ولا أذكر فيما نشره من الشعر آنذاك أوألقاه: ما يغفل لحظة عن بلاده ومدينته وأهله الذين شُرّدوا إلى مختلف المدن العربية .. ومع ذلك ظلّ يمتلك ثقةً وقناعةً راسخة بأن تلك الأرض لابدّ عائدة إلى أصحابها.. وأنهم لابدّ راجعون إلى بيوتهم. تجلّت السمة الأساسية.. ومازالت لشعره في الالتزام, واستطاع منذ يفاعته أن يقدمه لنا كعلامة فارقة لمسيرته الشعرية.. كان فقيراً شأن رفاق جيله ولربما استطاعت هذه الأسباب مجتمعة أن تخلق لديه وفي نفسه طاقة لاتنضب وصوتاً شعرياً فلسطينياً لا يخبو فظلّ شعره بين أقرانه وبين شعراء فلسطين: فاتحةً لشاعر شاب يَعِدُ بالكثير في المجال الشعري بعامة وفي مجال الشعر الملتزم بخاصة. كان يعاني في حياته المديدة التي أمضاها في سورية وفي دمشق بشكل خاص.. من ألم الحياة وآلام فلسطين, فخلق بذلك ملتزماً وظلّ هكذا حتى الآن.. فكانت جلّ قصائده شعراً سياسياً- في الغالب- يمتحّ من ذاكرةٍ ومخزونٍ وطاقةٍ خلاّقة وفق مارآه جمهور الشعر والأدب. أيام ذاك كانت تأتينا قصائد شعراء الأرض المحتلة لتوفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم: صوتاً ينبع من قلب المأساة والمعاناة.. صوتاً متمرداً يرفض الموت وحراب الاحتلال فوق رأسه.. وكان أحمد دحبور آنذاك شاباً في مقتبل العمر وشاعراً يقدم (قصيدة فلسطينية) لاتقلّ روعة عما أبدعه أقرانه.. كان يقول لفلسطين: (آتٍ .. وتسبقني يداي..) فهو علاوة على حنينه ومأساته: تسبقه يداه لتتلمّس ترابها وكأن حواسه وعقله وقلبه تجمّعت كلها في هذه الصورة التي تمنح اليدين قدرة الكشف والتقديس والشوق والمستحيل الذي يتحوّل إلى ممكن!. نشأ أحمد دحبور في بداية حياته الأدبية, والدنيا مشغولة بالأسماء الكبيرة في البلدان العربية.. ومنها الأسماء التي أغرقت الشعر في بحور الترميز والتغريب وفي بحور الأسطورة وفضاءاتها وظلالها التي اكتنفت القصيدة العربية.. بيد أنه اختطّ لنفسه طريقاً ارتضاه إذ قدم شعراً واضحاً قريباً من القلب يعتمد الموسيقا ووحدة التفعيلة, ولكأنه أراد لشعره السياسي أن يظل حاضراً في الجمهور الفلسطيني والجمهور العربي, وتلك سمة لازمت القصيدة السياسية الملتزمة قبل ذلك وبعده.. فأدونيس صاحب (القصائد الصعبة!) قال عن اللاجئين الفلسطينيين في الخيام: (قالت لنا آهاتنا شدوا الرحال إلى بعيْد أو فاسكنوا خيم الجليد فبلادكم ليست هنا!). ويوم قرأ الناقد الشاعر كمال خير بك قصائد أحمد دحبور أوائل السبعينيات, قال: هذا الشاب شاعر موهوب فانتظروا له مستقبلاً شعرياً جيداً فانظر إلى الدلالة الجميلة التي توحي بها هذه القصيدة (آتٍ.. وتسبقني يداي). وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية كانت الدنيا لاتسعه من الفرح ومن الشعور المتوقد بأن عودة فلسطين قادمة.. وكنا نقرأ معه بشوق قصيدة محمود درويش وهو في الأرض المحتلة. ولأن (العاصفة وعدتنا بنبيذ وبأقواس قزح). فكان يطيرمن الفرح وحينما عاد إلى الأرض المحتلة ليعيش في دياره: عانى ماعانى.. وشهد بألم كبير ماحدث ويحدث بين الإخوة!.. ...وغاب عن دمشق طويلاً, فانقطعت أخباره عنّا إلا مانشاهده أحياناً في بعض الفضائيات العربية أو في الأخبار الأدبية والثقافية.. وها قد عاد إلى سورية ليشارك في تأبين الشاعر الراحل محمود درويش ليكتشف أن جراحه وآلامه قد فتكت برئتيه, فأدخل إلى مشفى الأسد الجامعي بدمشق وإلى غرفة العناية المشددة ليبدأ علاجه في المدينة التي أحبها وأحبته فاحتضنته كما تحتضن الأم وليدها الغائب.. ووجد في صدرها حناناً ألِفَهُ منذ زمان وكان اليوم أشد,ّ إذ عاد إليها وهو مريض.. وها هي الشام تعيد إليه ذكرياته الماضية ومشاوير شبابه.. وتسقيه من مائها فراتاً زلالاً, وتحنو على جراحه تمسحها باليد والقلب الشفيق حتى يشفى. أحمد دحبور: حمداً لله على السلامة
|
|||||||||||||||