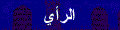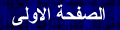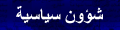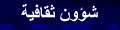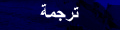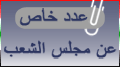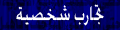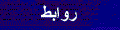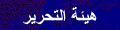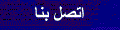|
ميادة الحناوي: سأغني لدمشق ما حييت بيئتي ساعدتني للوصول والشهرة تجارب شخصية استمرت بها ضمن مشهد فني يتعثر بأزماته, تغيب الأصالة عنه ليصبح فن الغناء بلا ملامح, إنها من نجوم الغناء القلائل الذين تمسكوا بفن الغناء العربي وأصوله وسط الضجيج الغنائي, حيث يضم أرشيفها الخاص أكثر من 300 أغنية حملت الكلمة والمعاني الراقية, حملت اللحن المؤثر والنص الغنائي الذي يخاطب المشاعر والوجدان بنبل, وجهتها المطربة للوطن والأرض والحب بأشكاله السامية. التقينا مع الفنانة ميادة الحناوي, فتحدثت لنا عن أغانيها, مسيرتها, ومحطات هامة في حياتها فقالت: في حي شعبي من أحياء مدينة حلب كانت الطفولة الأولى ضمن أسرة مكونة من عدنان, عثمان, وفاتن, التي سبقتني إلى عالم الغناء, أما الوالد والوالدة فقد عرفا بأصواتهما الجميلة وهكذا نشأت في أسرة تعشق الفن, منذ صغري سمعت أم كلثوم وعبد والوهاب وصالح عبد الحي, كما غنيت الأغاني الصعبة والأدوار والموشحات وعمري سبع سنوات مثل (لسه فاكر) لأم كلثوم و (ليه يا بنفسج), فالبيئة المحيطة بي ككل ساعدتني بالوصول إلى ما أنا عليه الآن خصوصاً أن حلب مدينة مشهورة بذائقة أهلها للطرب ومعروفة بإنجاب الأصوات الأصيلة وكم سمعنا عن مطرب عظيم تعامل مع جمهور حلب كمعيار حقيقي وامتحاني لأغانيه وصوته, انتبه الأهل لموهبتي فشجعوها وحفزوا على صقلها بالاهتمام والعناية. كنت على الدوام ومنذ نعومة أظفاري أحلم بلقاء العمالقة في الفن, فاستجاب لي ربي والتقيت الموسيقار محمد عبد الوهاب في بداياتي حيث استمع إلي في دمشق وأعجب بصوتي, ثم ذهبت إلى مصر وكانت المحطة الأكثر تأثيراً في حياتي, بعدها التقيت بكبار الملحنين في مصر من محمد الموجي إلى بليغ حمدي, سيد مكاوي, رياض السنباطي, محمد سلطان, فاروق سلامة, حلمي بكر وعمار الشريعي, وغنيت من ألحانهم, وكانت لكل تجربة ميزتها الخاصة والمختلفة عن الأخرى, وأعتبر أن الانطلاقة التي أسست لي في عالم الغناء هي أغان من ألحان بليغ حمدي مثل (فاتت سنة) و (الحب اللي كان). أما تجاربي مع العمالقة من الملحنين والشعراء فقد خلقت عندي الدوافع للسير نحو فن عريق, إذ علمتني أن أحترم فني وجمهوري وأقدم الأجمل من الأغنيات ذات المضمون الراقي, علمتني تلك التجارب أن أتعب وأجتهد ولا أستعجل أي شيء مهما حمل من إغراءات, إن كانت شهرةً أو مالاً أو ثراء, فكان علي أن أدقق وأهتم وأبحث قبل الدخول في أي تجربة فنية كي أتمكن من التميز وأصنع اسماً محفوراً بمشوار فني جميل وأغنيات يرددها الناس على مر الأجيال, حقيقة إن تجاربي مع صانعي العصر الذهبي للأغنية لا تنسى ولا أنسى تجربتي مع الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب الذي تبناني وأنا ابنة ستة عشر عاماً, فعلمني التواضع والبساطة وأسلوب الغناء الحقيقي بحرفياته وتفاصيله وأصوله, كما أنني لا أنسى أبداً تجربتي مع الشاعر محمد مهدي الجواهري حيث كان لي الشرف العظيم بالتعامل معه وغناء كلمات قصيدته دمشق المجد فعرفت من خلالها وقع الكلمة الراقية على الأنفس, أما بالنسبة إلى النقد الفني فإنه يكون بناءً عندما يوجه الفنان إلى الأفضل ويشير إلى نقاط الخلل في فنه ونتاجه ويكون مبنياً على احترام الفنان لا تجريحه, ولا يجوز التدخل في حياة الفنان الخاصة لأنها لا تعني أحداً غيره, أما أصحاب الأقلام الصفراء غير جديرين بالاحترام لا من قبل الفنان ولا من قبل القراء. الوجه الآخر لي بعيد عن عالم الفن هو أنني ست بيت من الطراز الأول, أطبخ بنفسي وأرتب بيتي بنفسي رغم وجود مدبرة المنزل, بطبعي بيتوتية لا أحب الخروج من البيت وأكره السهر والضوضاء, أحب أسرتي وأهلي ومتعلقة بهم بشكل كبير, والجميع يعرف أنني على مدى مسيرتي الفنية أعتمد على شقيقي عثمان كمدير أعمال أستشيره في كل أمر, في خياراتي الفنية وحفلاتي وأغانيّ, وهو الرفيق الدائم لي. أحب الأطفال كثيراً, فالطفل ذاك الكائن الجميل هو عالم بحد ذاته وأتمنى أن ألتقي بالنص الجميل كي أغنيه له. أسعى للأعمال الخيرية والاجتماعية إذ أعتبرها جزءاً من رسالتي الفنية, وكان لي شرف إقامة حفلات كثيرة ذهب ريعها لخدمة أطفال ومرضى وجمعيات كجمعية (أطفال المبره) و (الهلال الأحمر) وغيرها الكثير حيث لا مجال لذكرها وأنا على استعداد دائم لأي مشاركة في الأعمال الإنسانية, فالفنان إن افتقد الالتزام تجاه قضايا بلده وأناسه, لا قيمة لرسالته, ومن الضروري أن يستثمر نجوميته في مجالات تعود بالفائدة على مجتمعه ويكون له صوته وموقفه, وأذكر أيضاً أنني أقمت حفلات لنادي الاتحاد الرياضي كتشجيع للرياضة لأنني أحبها, فأحد هواياتي المفضلة بعد قراءة الشعر هي متابعة المباريات الرياضية. يهمني الجمهور بشكل كبير وهو أحد الأقطاب المهمة في حياتي, إنه الحكم الأساسي على الفنان, وبدون الجمهور لا يساوي الفنان شيئاً, فهو الذي يدفعه إلى الأفضل وهو الذي يشجعه وهو يطرد الهابط من الأغاني, فكم من أغنية بقيت عقوداً حيث سجلها الجمهور في ذاكرته وحافظ على مكانتها, وكم من أغنية رديئة كان عمرها قصيراً, وقصيراً جداً, قد لفظها الجمهور, والمحطة الحاضرة دوماً في ذاكرتي وإلى آخر عمري هي لقائي بجمهوري عندما غنيت في أول حفلة في بلدي وكانت انطلاقتي الحقيقية نحو الاحتراف الفني عام ,1980 وإن تابع قطار العمر مسيرته, فيقف في أخرى, لكنها حزينة تحفر أخاديد في القلب والذاكره وهي وفاة والدتي رحمها الله, فكانت محطة مؤلمة جداً ومحزنة لأنها بالنسبة لي كانت العالم برمته, فتركت فراغاً إملاؤه صعب, فالحياة بأكملها محطات وتجارب متناقضة منها المفرح ومنها المحزن وكل تجربة تترك أثرها خلفها. يمكن للأغنية أن تخدم الوطن عندما تحمل الكلمة الراقية, واللحن الجميل, والغناء كسائر الفنون, عليه أن يحمل الهدف النبيل يوظفه في خدمة الوطن الذي أعطانا الكثير ويحصل حتماً عندما تقدم الأغنية ما يرفع ذائقة الناس ويرقى بأحاسيسهم, لا أن تحمل لهم الإسفاف والابتذال والسطحية, كما نرى في تلك الموجة الدارجة من الأغاني الهابطة التي تعتمد على الجسد وعريه أكثر من الصوت والموسيقا والغناء بحد ذاته, وما يحزن أن وطننا عامر بالجمال, فهناك الحضارة والتآخي والتاريخ العريق الذي يليق به التغني والتمجيد, وتلك الأغنية التي تتجه للوطن والأرض والمكان ووجدان الناس هي التي تبقى في ذاكرة الأجيال, فهل يمكن لأي منا أن ينسى غناء فيروز للشام وبيروت ومكة, وهل يمكن أن ننسى ما غناه محمد عبد الوهاب وأم كلثوم للوطن والحب والجمال, إنها أغان باقية تتجسد فيها رسالة الفن. غنيت لبلدي سورية أغاني كثيرة, منها (دمشق المجد), (سورية يا بلدي ويا شرفي), (شآم), وأقول إنني أشعر بالفخر والاعتزاز والخشوع عندما أغني للشام وأنقل للدنيا بأجمعها عراقتها الضاربة الجذور في الأصالة, كما أنني غنيت ل (بيروت) رسائل محبة وتآخ, فالحس الوطني حاضر دوماً في وجداني وأغانيّ, والوطن عندي كالأم والأب وبلدي دائماً في قلبي, وأينما سافرت لا أحس بالراحة والدفء والحنان إلا عندما أعود إليه, غنيت لسورية وسأغني لها ما حييت.
|
|||||||||||||||