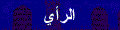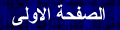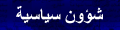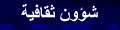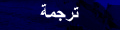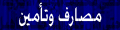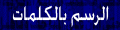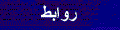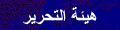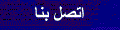|
ابتسامتها التي... الرسم بالكلمات كنت هناك أجلس في ذلك المقهى البحري الوادع. أنظم همومي حسب الأولوية, محاولاً قتل الوقت بانتظار وكيل الشركة الخليجية. ثمة مقابلة سيجريها معي لتحديد مصيري. إما الحصول على فرصة العمل, وإما أن أصبح خارج التغطية... خارج الحياة ويلقى بي إلى البحر. مرت نصف ساعة على موعدي مع الوكيل, ومازلت أنتظرُ مرمياً على حافة الوقت خارج الزمن ألوك فراغي ولا أهضمه. أستعرض شريط حياتي.. همومي.. خيباتي.. حماقاتي التي كان آخرها سبباً في طردي خارج العمل - طبعاً فقدت عملك.. هكذا أنت دائماً تغامر برزقك من أجل المبادئ ولا تحصد سوى الخيبة والفقر. تذكرت عبارة زوجتي على الهاتف والتي ما زالت تطرق فوق مسامعي بلهجتها الساخرة وتهكمها القاتل. وما برحت أتأمل في المدى البحري, ثم أغوص في بحر ذاتي.. أطفو مسرعاً إلى السطح لألتقط أنفاسي, ثم أغوص مرة أخرى, يصادفني ذلك الأخطبوط الكبير المتعدد الأرجل والأذرع المسمى (الميزانية) يحيط بي من كل جانب محاولاً خنقي وابتلاعي, أهرب منه مسرعاً. وأطفو إلى السطح مرة أخرى لاهثاً باحثاً عن الهواء وأتابع انتظاري. أرتشف ما تبقى من فنجان قهوتي ويرتشفني خوف من قدر حتمي سيتجلى بعد قليل. أتلفت يميناً ويساراً علّي أعثر على ذاك الرجل الثري بلباسه الشديد البياض يحمل بيده أوراق مصيري. في بحر انتظاري الذي جاوز نصف الساعة تنبهت إلى أني لم أعد أنظر إلى الساعة ولم يعد ذاك الانتظار يضطهد كياني بل إنه يأخذ لوناً آخر وطعماً آخر.. شعرت أني متمسك به متناغم معه. يبدو أنني كنت مستسلماً للأطياف المغناطيسية التي راحت تنشرها تلك الحورية الصغيرة على طول الشاطئ الرملي. البحر أيضاً بدا حالماً وأكثر رومانسية لكنه ظل صامتاً يتابعها بنظراته. البحر لم يقل شيئاً... ابتسامتها التي قالت, ودون أن أدري وجدت نفسي بداخلها.. أشكل لوناً من ألوانها, أنا الذي أدمنت السفر في جسد المرأة, واعتاد نظري متعة مراقبته وسبر أغواره.. اعتاد الولوج في أبعاده وصولاً إلى أقصى المنحدرات وعورة وأشدها خطورة, تجدني الآن أتوغل في تلك الابتسامة متسكعاًَ في شوارعها بكسل لذيذ ولا أرغب في الوصول أبداً. وغدوت أقبع داخلها..وإذا ما تم تصويرها أظهر في الصورة (رجل داخل ابتسامة) تلك الفتاة كانت في ربيع العمر. سمراء نحيلة يانعة الجسد في بداية تفتحها الأنثوي, بدت كما لو أنها في الرابعة عشرة تنتقل بالكاميرا على شاطئ البحر من مكان إلى آخر, تقوم بالتقاط الصور لمجموعة من النساء, والأطفال خرجت بهم للتو من المقهى.. كانت تلك المجموعة تسير خلفها بسعادة. مازالت تمشي على الشاطئ البحري. وبين الفينة والأخرى تطل ابتسامتها على الدنيا تمتد أبعد من الشاطئ متجاوزة حدود البحر, متحكمة بحركة المد والجزر. البحر لم يقل شيئاً.. كان مستسلماً لسحرها.. ابتسامتها التي قالت.. وما برحت أنظر إليها بكثير من الترقب واللهفة وبدهشة طفل يتابع انطلاق الأسهم النارية في ليلة عيد. أقف الآن في يومي الأخير الذي يسبق انتهائي أو ابتدائي. أن أحصل على فرصة العمل إنما يعني ابتدائي من جديد وإعادة انتمائي إلى الحياة أن أفقدها يعني فقدان وجودي وإقامتي.. واقترابي من الموت. وإذ كنت على شفا حفرة من النار, كانت تعبر ومضات تلك الابتسامة من جانبي تلامس أطراف روحي بشيء من البرودة. وتمتد شيئاً فشيئاً أبعد من الشاطئ.. تصل حدود المقهى تعبر الأشياء والناس. البحر بدا صامتاً يتأمل تلونها واتساع أطيافها.. وقد غادر وظيفته الطبيعية غادر مده وجزره وترك مكانه فوق الأرض... ترك كائناته البحرية وشعبه المرجانية.. غادر موقعه وجلس معي على المقهى يراقبها بمتعة غريبة. البحر كان صديقي... لكنه ظل صامتاً. البحر لم يقل شيئاً... بل ابتسامتها التي...
|
|||||||||||||||||||||