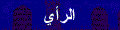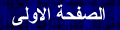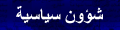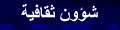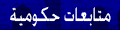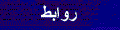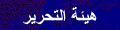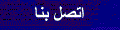|
نقــــد القــــراءة وقـــــراءة النقــــــد ثقافة فإذا كنا نعتقد أن القارئ ، الناقد، المتبصر، يضاهي الكاتب الأصلي إبداعاً وموهبة فلا بد من أن نطرح السؤال الهاجس الذي يقض مضاجع الكثيرين من القراء ذوي الذائقة الفنية والجمالية الذي يصاغ كالتالي: لماذ نقرأ نصاً يزيد الفكرة التي يفترض أنه يبسطها ويشرحها غموضاً؟ بل لماذا يكتب هذا النص أصلاً إذا لم يكن بمقدور كاتبه أن يقدمه ببساطة وسهولة للغير؟ ومن المسؤول عن ذلك الغموض واللبس في هذه الحالة، الكاتب أم القارئ؟ وهل كل ما يكتب يمكن أن يقرأ؟ وما جدوى قراءة نص يدفع لخواتيم واستنتاجات غير مفهومة؟ أم أن الأمر في هذه الحال لا يعدو أن يكون مجرد رغبة في الكتابة من أجل الكتابة ليس إلا؟ أم أن هناك دوافع أخرى تتعلق بكون الكاتب يريد أن يستخدم الألفاظ والعبارات والجمل الغامضة ليقال إن قراءته تكسر الرأس. فما معنى أن نقرأ عناوين مثل حداثة الجسد أو حداثة الروح أو حداثة الحداثة وما الذي يفترض أن تقدمه تلك العناوين؟ وهل تتمكن النصوص التي تشير إليها من فك الغموض الذي تستبطنه؟ وما معنى أن يكون الجسد حداثوياً أو تكون الروح كذلك؟ أياً يكن الأمر فإن قراءة نص فلسفي أو أي نص آخر لا تساوي الجهد الذي أنفق عليها إذا لم تسمح للقارئ بفهم مدلولاته ومعانيه والوقوف على ما يخفيه وما يظهره وما يحتمله من تأويلات ودلالات بما يمكنه من القبض علىالفكرة وتمثلها بحيث تصبح جزءاً منه من غير أن تتنكر لكاتبها الأصلي، هي دعوة إذا للتعامل مع الكتابة كضرب من المسؤولية التي تلقى على عاتق صاحبها فتدفع به لتبسيط المصطلحات وشرح الجمل وتوضيح العبارات والامتناع عن تركيب الألفاظ الغامضة بداعي أنه لا يكتب للقارئ العادي وإنما للقارئ المتخصص وهنا ينسى الكاتب أو يتناسى أن الكتابة كما يقول: كافكا هي ضرب من الصلاة وكل صلاة لاتغدق الخشوع والرحمة في قلب صاحبها ليست إلا شكلاً من أشكال المباهاة والتقليد. فالكلمة إذ تكتب أو تقال لا معنى لها ما لم تحض على الحوار والتباحث مع الآخر، الكاتب أو القارئ مع الذي تحاوره بهدف تجاوزه أساساً؟ فهل تحاور هيدغر مع ديكارت أو مع أفلاطون لولاإيمانه بإمكانية تجاوزهم من خلال تقديم وجهة نظر جديدة تقدم للقارئ فهماً جديداً لتاريخ الفلسفة برمته. إن الكتابة بهذا المعنى امتداد لصوت النفس التي تجيد فن الصمت والإصغاء، فنحن إذ نكتب أو نقول فبهدف تملك الواقع واستحضاره لأنه بالتملك وحده نعيد الاعتبار لواقع نريد تشكيله بصورة جديدة ليليق بنا كبشر فشرط الوجود الحقيقي يبدأ من التملك، بذاك فقط يصبح الواقع رهن قبضتنا، ولكن ما الذي تغير في مفهوم الوجود حتى أضحت الكتابة فيه أو عنه بوحا وصلاة واستحضاراً له وفق أعمق صوره؟ هل اختلف الوجود في الماضي عنه في الحاضر؟ وهل سيختلف عنه في المستقبل؟ أم أن الوجود هو الوجود لم يتغير، وما تغير ليس إلا الإنسان ، القارئ والكاتب على السواء، الإنسان الذي يقدم قراءات مختلفة ومتغايرة للوجود تتوافق وبنيته الذهنية والمعرفية وموقعه الإيديولوجي وذلك بهدف استحضاره أو بلغة هيدجر الارتماء في أحضان الوجود كما يفعل من يستحم في البحر، هذا الارتماء الذي ليس في حقيقة الأمر إلا فعل التفكير الذي يعبر عنه بأدوات كثيرة تؤسس جميعها لذلك الفعل وتعمقه. إن التفكير في الوجود وامتلاك الوسائل والأدوات اللازمة لذلك هو الذي يجعل الوجود يأتي صوبنا وبالتالي يجعل مساءلتنا له عبر اللغة ممكنة، غير أن المساءلة، هاهنا إذا لم تلق ظلاً من الإلفة والفهم على الوجود لا داعي لها على الإطلاق لأن الواقع سيصبح عندها أكثر إبهاماً وغموضاً. لكن الواقع الذي يقذف الإنسان نفسه كي يفهمه بدلالة الكلمة اللغة قد يغرر به حين يصبح على يقين مفاده أن الكلمة التي يستخدمها إنما تعبر بالضرورة عن علاقة ما ترتبط بالواقع الذي أنتجت في سياقه، الأمر الذي يدفعه لنقلها من حالة للوجود عبرت عنه الكلمة في زمن ما ومكان ما إلى حالة أخرى قد لاينفع معها استخدام الكلمة ذاتها لاختلاف دلالاتها وسياقاتها ومعناها حتى لو ظلت هي هي كما يحلو للبعض أن يرى ، فالحداثة مثلاً التي ولدت في زمن ومكان ما وأنتجت مجتمعاً أوروبياً يفكر في سياقها وينتج في ضوء محدداتها لم تعد تصلح للاستخدام في مجتمعات كثيرة أو في أمكنة أخرى من العالم لاختلاف البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المجتمعات عن تلك البنى التي أنتجت الحداثة في سياقها، لذلك لم يعد لحديثنا نحن أمة العرب عن مفهوم الحداثة أو العقلانية أي قيمة تذكر لأن الوجود الذي نعيشه اليوم قد تم إنتاجه وقراءته وتأويله في سياق مختلف كل الاختلاف عن السياق الذي أنتج الحداثة الأوروبية ولذلك بات الحديث عن الحداثة والعقلانية ضرباً عن الصياح في واد لا قرار له. فما معنى أن يرفع شعار الحداثة في بلدان تعيش حالة ما قبل المجتمعات الحداثوية بعشرات القرون. إن لم نقل أكثر؟ وما معنى الحديث عن العقلانية في وقت اختفت منه كل المظاهر الدالة على استخدام العقل لفهم الواقع والوجود الذي نحيا فيه. فرفعنا لتلك الشعارات، شعارات الحداثة والعقلانية والديمقراطية والتغني بها ما هو إلا بقصد إيهام الآخر، الذي أنتج تلك المفاهيم وأعاد بناء واقعة في ضوئها إلى هذه الدرجة أو تلك. ، إننا على اطلاع ومعرفة نظرية واسعة بتلك المفاهيم تضاهي معرفته به، وهذا يشبه إلى حد بعيد ما كنا نفعله ونحن صغار حينما كنا نمشي في واد أو طريق مخيف فنرفع أصواتنا بالغناء علنا نستمد بذلك بعض الشجاعة من صوت نعرف أنه لن يحولنا إلى شجعان، وها نحن نفعل الآن الفعلة ذاتها فنشارك في ندوات تقام حول الحداثة والعقلانية وما يدور الحوار حوله في الغرب لا لشيء إلا لكي نستمد بعضاً من الثقة من وهم خلقناه بأنفسنا من جهة، ولكي يقال عنا إننا نماثل الغرب ونضاهيه معرفة من جهة أخرى.
|
|||||||||||||||